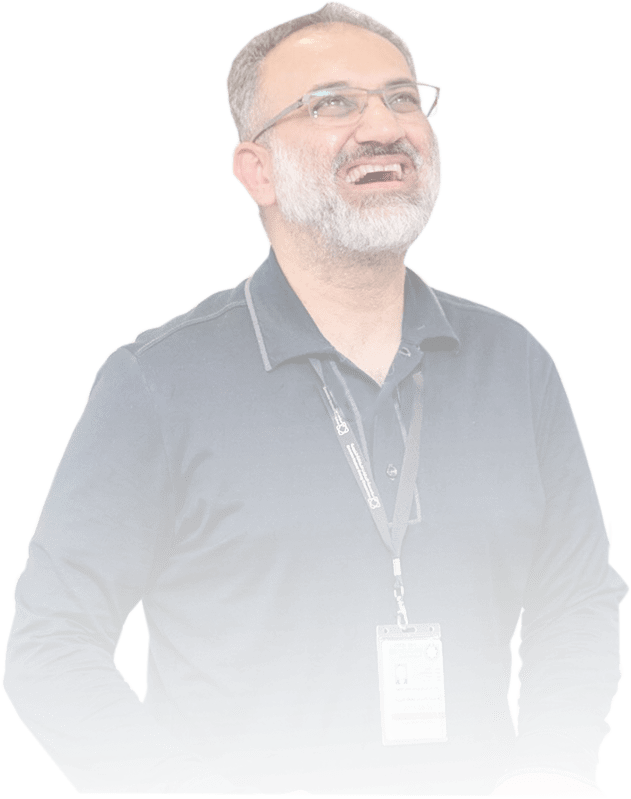
Nuclear personality before nuclear plant i don't charge for being fair
blog
categories
HAPPY SUPPLIER +
HAPPY OWNER =
SUCCESSFUL PROJECT
نسخت الكلمات التالية من مقطع صوتي، و لا أعرف كاتبها، و هي على لسان مواطن غربي. أهديها للمدنيين الفلسطينيين.
لقد أخبروني من هو العدو قبل حتى أن ألتقيه. أخبروني ما الذي يجب أن أخاف منه. رسموا لي صورًا بالدم و الدخان، و أصواتٍ مرتفعةٍ بالغضب، و قبضاتٍ مضمومةٍ في الاحتجاج، و سموها شرًا. أروني لقطات إخبارية لإطارات مشتعلة، و وجوه مقنعة، و حجارة تطير في الهواء و قالوا: "هؤلاء هم الإرهابيون". لا أسئلة، لا سياق، مجرد اسم و وجه لتخشاه. و مثل الكثيرين، صدقتهم، ليس لأني كنت قاسيًا، بل لأن ذلك كان في كل مكان: على التلفزيون، في الصحف، و في الأحاديث الهادئة التي يدلي بها الناس عندما يعتقدون أنهم يعرفون الحقيقة. لكن الحقيقة لها طريقة في الطرق على بابك عندما لا تتوقع ذلك.
أرأيت! من السهل أن تصدق القصة، عندما لا تبرح حيك أبدًا. عندما تجلس مرتاحًا في غرفة معيشتك، تقلب القنوات و تظن أن العالم بعيد جدًا ليهُم. لقد علموني أن أرى فلسطين كمنطقة حرب، لا كمكانٍ يلعب فيه الأطفال كرة القدم في شوارع متربة. لا كمكانٍ تضفر فيه الأمهات شعر بناتهن، أو يعلم فيه الآباء أبناءهم كيف يكونون رجالًا بشرف. لم يخبرني أحد عن الابتسامات، أو القصص، أو القوة. لقد أعطوني فقط انفجارات، و صافرات إنذار، و عناوين، و قبلت ذلك. لكن شيئًا ما لم يكن على ما يرام. كان هناك صمت بداخلي بدا صاخبًا، كلما رأيت قصفًا آخر يُوصف بأنه "رد فعل".
كلما رأيت مدنيين يتحولون إلى إحصاءات، ظل شيء بداخلي يسأل: "هل هذه هي القصة كلها؟" لذا، بدأت أبحث عن المزيد، و لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ظهرت التشققات. مجرد اللغة وحدها أخبرتني مَن المُفترض أن يكون إنسانًا و مَن المُفترض أن نخشاه. أخبرتني أن طرف ما "مدافعون"، و الطرف الآخر "مسلحون". لطرفٍ ما "خسائر"، و للطرف الآخر "ضحايا". لم يذكروا أسماء القتلى الفلسطينيين أبدًا، إلا لربطهم بجماعة غامضة. لم يقولوا أبدًا إنهم أمهات، و معلمون، و شعراء، و طلاب، و أجداد. لم يقولوا أبدًا إنهم بشر. و عندما بدأت أرى ذلك، حقًا أراه، أدركت كم كانت الكذبة عميقة.
رأيت أطفالًا يسيرون إلى مدارسهم عبر حواجز توجّه إليهم البنادق. رأيت منازل تُهدم في الليل بينما يبكي الرضع تحت ضوء القمر. رأيت صلوات تُهمس بين الجدران، بين القصف، بين الجنازات، و لم يبدُ أي منها كالإرهاب بالنسبة لي. بدا ذلك كبقاء. بدا كأناسٍ جردوا من إنسانيتهم، لدرجة أن العالم لم يعد يرمش عندما يموتون.
حينها جاء الغضب. ليس تجاه الأشخاص الذين علموني أن أخافهم، بل تجاه الأصوات التي كذبت عليّ. تجاه الأصوات التي جعلتني أنظر إلى مقاتل من أجل الحرية و أرى مجرمًا و التي جعلتني أنظر إلى شعب محتل و أظن أنه المعتدي. كان الغضب حقيقيًا، لكنه لم يكن بلا هدف. كان له غرض:
دفعني لأن أتخلص مما تعلمته، لأن أحفر أعمق، لأن أصغي، حقًا أنصت إلى أصوات أولئك الذين أُسكتت أصواتهم. و أقول لك هذا:
بمجرد أن ترى الإنسانية في شخصٍ علموك أن تكرهه، لا يمكنك العودة. لا يمكنك أن تعود لراحتك، و ربما لا ينبغي لك، لأن ذلك الانزعاج هو صحوة ضميرك. انها الحقيقة تطالب بمساحة في روحك.
يسمونهم إرهابيين فلسطينيين، لكن عندما فتحت عينيّ، كل ما رأيته كان أناسًا شجعانًا، جميلين، محطمين، و أناسًا لا ينكسِرون. و كان ذلك مجرد البداية. لم أذهب باحثًا عن ثورة. لم أبدأ رحلتي لتغيير معتقداتي. في البداية، أردت فقط أن أرى بنفسي. بدأت العناوين و النقاشات و التسجيلات الصوتية تبدو متشابهة: باردة، بعيدة، و مُسيّسة. لقد تعبت من أن يُلقنوني آراءً متخفيةً في ثياب الحقائق. لذا، حزمت شكوكي مع حقيبتي، و وضعت قدمي في عالم لم أره إلا من خلال الشاشة.
لم تكن فلسطين بالنسبة لي مكاناً، بل كانت فكرةً، كلمةً ملفوفةً بالجدل، و مشهداً عابراً في النشرات الإخبارية. أردت أن أراها بعينيّ، أن أشعر بترابها تحت قدميّ، أن أسمع الأصوات دون تصفية. و ما وجدته لم يكن ما توقعت. من اللحظة التي عبرت فيها إلى تلك الأرض، بدأ كل ما ظننت أني أعرفه يتزعزع. كان الهواء ثقيلاً، ليس بالغبار فقط، بل بشيء أعمق - نوع من الانتظار. توتر يعيش على أكتاف الناس و في صمتهم، في الطريقة التي ينظرون فيها خلفك قبل أن ينظروا إليك. لكن حتى في ذلك التوتر، رأيت شيئاً آخر. شيئاً لم يصل إلى العناوين الرئيسية: ضحكات، كرم ضيافة، جدة تقدم لي الشاي في قرية لم أستطع نطق اسمها. أطفال يجرون حفاة فوق الأنقاض و كأنها ملعب. رجل فقد أخاه و ما زال يبتسم عندما يتحدث عن الأمل. لم يكن هذا ما قيل لي أن أتوقعه.
يقولون: "لن تفهم الناس حتى تمشي في شوارعهم"، و هذا صحيح. مشيت في أزقة تحمل ندوب الرصاص، و رأيت جداريات للشهداء على جدران آيلة للسقوط. لكني أيضاً جلست في غرف معيشة حيث تُحكى القصص، ليس بغضب بل بحب، حيث الماضي لم يُنسَ بل يُكرم. سمعت قصصاً عن عمليات طرد قسري، عن حواجز حوّلت الحياة اليومية إلى مقامرة. شاهدت أباً يحمل ابنته النائمة، بينما يطن صوت طائرات مسيرة من بعيد، فاستوعبت الأمر: هذه ليست حرباً. هذا أناس يستيقظون كل يوم تحت وطأة الاحتلال، و يختارون مع ذلك أن يعيشوا. حينها بدأت الحقيقة تنقش نفسها في قلبي. ليس في الخطب، و لا في السياسة، بل في اللحظات الإنسانية الهادئة: في عَينَي طفل سألني إذا كان العالم يعلم بما يحدث. في صوت الأذان الهادئ الذي يتردد في الشوارع المدمرة. في طريقة دعاء الناس بأيدٍ مفتوحة، حتى عندما لم يعد لديهم ما يتمسكون به.
و كلما رأيت أكثر، أدركت كم أخفوا عني. ليس الحقائق فقط، بل الوجوه، و الإنسانية، و الكرامة. لقد أعطوني أجزاءً من القصة، ملتوية و مجردة من السياق. تحدثوا لي عن الصواريخ، لكنهم لم يتحدثوا عن الحصار. عن المقاومة لكن ليس عن القمع. عن الخوف لكن ليس عن الإيمان. أروني العنف لكن ليس عنف التشريد. لم تغيرني الرحلة دفعة واحدة. لم تكن كالصاعقة. بل كانت انفتاحاً بطيئاً، من النوع الذي لا يطلب الإذن. الحقيقة لا تنتظرك حتى تكون مستعداً. إنها تظهر فحسب، و عندما تفعل، لا تهتم بسياساتك. إنها أعمق من ذلك. تخاطب روحك، و روحي كانت تصغي.
جئت باحثاً عن إجابات، لكن ما وجدته كان أكبر من الحقائق، أو اللقطات المصورة. وجدت أناساً تم تشويه سمعتهم، لمجرد أنهم تجرأوا على البقاء أحياء. وجدت الحب وسط الأنقاض، و الإيمان وسط النار. و شيئاً فشيئاً، وجدت الحقيقة. ليس تلك التي علموني إياها، بل تلك التي كانت موجودة دائماً، تنتظر من يهتم بما يكفي ليراها. هناك فرق بين مشاهدة شيء يحدث،و الوقوف في وسطه. بين سماعك عن المعاناة، و استنشاقك للهواء حيث تعيش تلك المعاناة. ما شهدته على الأرض لم يكن مجرد سياسة، بل أناساً يحاولون النجاة في واقع كان سيكسر معظمنا.
لا يمكن لأي عنوان رئيسي أن يلتقط ذلك، و لا لأي فيلم وثائقي أن ينقله بالكامل. لأنه ليس فقط الأشياء المرئية - الحواجز، المنازل المدمرة، الأسلاك الشائكة - بل الثقل غير المرئي الذي يحمله الناس كل يوم. أتذكر أول حاجز رأيته. لم يكن كما في الأفلام. كان أبطأ و أقسى. طابور من الناس: كبار، صغار، مرضى، طلاب، جميعهم ينتظرون. ليس من أجل العدل، و لا الإنصاف. فقط ليعبروا. فقط ليذهبوا إلى المدرسة أو العمل أو موعد الطبيب.
وقف الجنود ببنادقهم معلقة بلا اكتراث على صدورهم، بالكاد ينظرون إلى الناس الذين يحملون حياتهم بين أيديهم. و الناس ينتظرون، ليس لأنهم تقبلوا الأمر، بل لأنه ليس لديهم خيار. يمكنك أن تشعر بالإرهاق في ذلك الصمت، و في الطريقة التي توقف الناس فيها عن الارتعاش. هذا ليس سلاماً. هذا بقاء تحت الضغط.
ثم كانت هناك المنازل. بعضها نصف قائم، و بعضها مدمر تماماً. جدران محطمة، أثاث متناثر مثل عظام. قابلت امرأة تعيش في خيمة بجوار أنقاض منزلها السابق. قدمت لي خبزاً و ابتسمت. سألتها: "كيف تحافظين على هذه القوة؟" فأجابت: "ليس لدينا رفاهية الانهيار." كان ابنها يلعب بجانبنا، يرسم في التراب بعصا. ذلك الطفل لم يعرف كيف تبدو الملاعب. كان صندوق رماله هو رماد ما كان يوماً بيوتاً لأطفال. هذا ما أصابني بأقسى ألم. يكبرون بسرعة في فلسطين. رأيت طفلة في العاشرة تقريباً، تتحدث بطلاقة إلى صحفي بإنجليزية عن الاحتلال، عن الحواجز، عن حلمها بأن تصبح طبيبة لمساعدة شعبها. ليس هذا هو الطفولة المفترضة، ولكنها تصبح كذلك عند إمكانية أن يكون كل صباح آخر صباح مدرسي. عندما تطن طائرات مسيرة فوقك مثل البعوض، تراقبك دائماً، تذكرك أنك لست حراً.
رأيت أولاداً يحملون الكتب بيد و الحجارة بالأخرى. ليس لأنهم يريدون القتال، بل لأن هذه أحياناً تكون اللغة الوحيدة المتبقية عندما لا يصغي أحد. لا يرمون الحجارة للتدمير، بل ليراهم العالم. ليصرخوا في عالم يبدو أنه أصمّ. فالإعلام يريك الحجر، لكنه لا يريك الدبابة. يريك النار، لكنه لا يريك الجنازة التي سبقتها. و رغم كل شيء، لا يزال هناك جمال. رأيت أناساً يزرعون الزهور في شقوق الأرصفة المدمرة. سمعت موسيقى تنساب من نافذة مبنى مهدم. شاهدت زوجين يحتفلان بزواجهما تحت أضواء خافتة في مخيم لاجئين، يرقصان على مستقبل ليسا متأكدين منه. هناك تحدٍ هنا، و فرح، في الاستمرار بالضحك، بالحب، بالعبادة، بينما كل شيء حولك يصرخ: "لم يعد لديك ما تخسره".
هذا ليس نزاعاً. تلك الكلمة نظيفة جداً، متوازنة جداً. هذا اضطهاد من طرف واحد، منظم، مقصود، و يُلفّ بالصمت، من قبل من هم إما خائفون جداً، أو مرتاحون جداً ليتكلموا. لكن عندما تمشي في تلك الشوارع، عندما تجلس في تلك المنازل، عندما تنظر في عيون أناس فقدوا كل شيء و ما زالوا يقدمون لك الشاي، تبدأ بفهم شيء ما: هؤلاء ليسوا ضحايا ينتظرون الإنقاذ. هم ناجون، مقاتلون، أرواح منحوتة من المقاومة و النعمة. و حالما ترى ذلك، لا يمكنك أن تنصرف. لأن الواقع على الأرض ليس مجرد معاناة. إنه قوة! قوة يحاول العالم تجاهلها، لكنه لن يستطيع محوها أبداً.
هناك لحظات في الحياة لا تستأذن لتغيرك. إنها تفعل فحسب. تتسلل عبر دفاعاتك، عبر منطقك، جدالاتك، و تضربك في ذلك المكان الهادئ حيث تسكن الحقيقة. بالنسبة لي، تلك اللحظة لم تأتِ بانفجار مدوّ. لم تكن لقاءً درامياً. بل جاءت في صمت، في سكون، في لحظة كانت إنسانية، لدرجة أنها فتحت في داخلي شيئاً لم أكن أعرف أنه مغلق. كنت جالساً مع عائلة في غزة. منزل بسيط، جدران عارية، بلا كهرباء، بضع وسائد على الأرض. الأب كان قد تبنى أيتاماً من القصف الأخير. بالكاد كان لديه ما يكفي لأطفاله، لكنه صنع مساحة. في تلك الليلة، دعوني لأشاركهم العشاء. الطعام كان بسيطاً: أرز، زيتون، القليل من الشاي. لكن الدفء، و الترحيب، كنت سأظن نفسي ملكاً من طريقة معاملتهم لي. لم يسألوني من أين أتيت، لم يسألوني عن معتقداتي، رأوني ضيفاً، و كان ذلك كافياً.
بينما كنا جالسين معاً، صدح صوت الأذان في الليل. لا كهرباء، لا أضواء، فقط النجوم و صوت الإيمان يطفو في الظلام. شاهدت العائلة كلها تقوم للصلاة. لا أحد أمرهم، لا تذكير، لا ضغط. مجرد إيقاع داخلي عميق يقودهم إلى سجاد الصلاة. لم أفهم الكلمات حينها، لكني فهمت الشعور، الطريقة التي وقفوا بها كتفاً بكتف، أعينهم مغلقة، قلوبهم مفتوحة. الطريقة التي قلّد بها أصغر طفل الحركات، ببراءة الأطفال. أصابني ذلك مثل موجة. في تلك اللحظة، بين ظلام غزة و تواضع ذلك المنزل، تحت نفس النجوم التي ترقبنا جميعاً، أدركت أنني لم أعد نفس الشخص الذي دخل. الحقيقة لا تحتاج إلى قنابل لتفجّر جدراننا. أحياناً، كل ما تحتاجه هو شاي ساخن، يدان تقدمانه بلا تردد، و صوت صلاة في الظلام.
هؤلاء الذين خسروا الكثير، الذين عاشوا كل يوم تحت الحصار، بدون ضمانات للغد، ما زالوا يصلون بالشكر، ما زالوا يؤمنون، ما زالوا يقفون أمام خالقهم بسلام في قلوبهم. ذلك النوع من الإيمان، ذلك النوع من السكينة وسط الفوضى. لم أرَ شيئاً مثله من قبل.لم أصلِّ تلك الليلة جسدياً، لكن شيئاً بداخلي انحنى، شيئاً بداخلي تحطم. و من ذلك التحطم، بدأ شيء جديد. كانت روحي تُنصت و تقول: "انتبه! هذه هي الحقيقة". لقد رأيت الكثير من الألم حتى تلك اللحظة: دماءً على الأرصفة، أمهات يصرخن على الحواجز، أطفالاً يحملون الصدمات في أجسادهم الصغيرة. لكن في لحظة الصلاة تلك، في السكينة، في الإيمان، في الكرامة الهادئة، أدركت أن ما أشاهده ليس مجرد صراع سياسي، ليس مجرد احتلال. إنه حرب روحية أيضاً. محاولة لسلب الناس إنسانيتهم، هويتهم، قدرتهم على العبادة، على الحلم، على مجرد "الوجود". و مع ذلك، هم يرفضون أن ينكسروا. حينها تغير شيء بداخلي.
جئت ظاناً أني سأراقب، ربما أفهم، ربما أتعاطف، لكني لم أتوقع أن أشعر بهذا العمق. لم أتوقع أن أُحرَّك، و بالتأكيد لم أتوقع أن أرى الإسلام. ليس كفكرة، ليس كديانة سمعت عنها من بعيد، بل كقوة حية تتنفس، قوة صمود، حب، تسليم، ليس للخوف، بل لما هو أعلى. تلك اللحظة لم تفتح عينيّ فقط، بل فتحت قلبي، و سألتني سؤالاً لم أستطع تجاهله: "إذا كان هؤلاء يحتفظون بإيمانهم وسط الجحيم، فبماذا أتمسك أنا في راحتي؟" لم تكن لدي الإجابة حينها، لكني عرفت شيئاً واحداً: أردت أن أفهم ذلك النوع من السلام، تلك القوة، ذلك الإيمان. و من تلك الليلة، لم أعد مجرد شاهد على قصتهم. كنت أكتب فيها.
لطالما سمعت كلمة "الإسلام" طوال حياتي: في الأخبار، في الأحاديث العابرة، في الوثائقيات التي بدت دائماً تركّز على الحرب، الصراع، السيطرة. كانت كلمةً تشعرني بالبعد، بالغربة، محملةً بافتراضات لم أتكلف عناء تحديها. ظننت أني أعرف معناها، ظننت أنها تتعلق بالطقوس، الأحكام، ربما الخوف. لكن كل ذلك تغير في لحظة واحدة. ليس في مسجد، ليس في نقاش، بل في سكون ليلةٍ، حملت من الحقيقة أكثر من أي كتاب قرأته في حياتي. ما رأيته في تلك اللحظة من طريقة وقوف تلك العائلة للصلاة، السلام الذي يغمر وجوههم رغم الفوضى من حولهم، حطم كل الأكاذيب التي غذوني إياها.
لم يكن الأمر مجرد دين، بل كان حضوراً، كان صموداً نابعاً ليس من الغضب، بل من التسليم. ليس للاضطهاد، بل لما هو أعظم. رأيتهم يصلون في الظلام، و النور الوحيد يأتي من النجوم فوقهم، فأدركت أن لديهم شيئاً لا أملكه. شيئاً لم أفهمه قط، شيئاً لم أبحث عنه حتى. اليقين! ذلك النوع من اليقين الذي لا يعتمد على الظروف، الذي لا يتلاشى عند سقوط القنابل، أو نفاد الطعام، أو عندما يدير العالم ظهره. يقين متجذر في الإيمان، ليس إيماناً أعمى، بل إيماناً وُلِد من صراع حي، من معرفة أن هناك غاية حتى في الألم. أنه لا ظلم يمر دون أن يراه من يرى كل شيء (الله).
لقد رأيته في طريقة وقوفهم، في انحنائهم، في همساتهم "الله أكبر"، بقلوب عرفت من الخسارة ما يفوق ما نتحمله نحن. و مع ذلك ينادون الله بالعظيم. و لأول مرة فهمت معنى ذلك. لم يكن عن الخوف أو الخضوع بالمعنى الذي ظننته دائماً. بل كان عن الحرية. الحرية الحقيقية، تلك التي لا يمكن سرقتها بالجنود، أو الحدود، أو القنابل. النوع الذي يعيش في روحك، دون أن يمسسه ضجيج هذا العالم. الإسلام في تلك اللحظة لم يكن مجرد دين. كان شريان حياة، مصدر كرامة، بوصلة تشير إلى الأمل، عندما تنعدم كل المؤشرات.
لم أرَ حباً بهذه البساطة من قبل: طريقة مشاركتهم الطعام، رعايتهم لبعضهم، ابتساماتهم رغم كل شيء. لم يكن تمثيلاً، لم يكن للعرض. كان حقيقياً، كان الإسلام عملياً. رحمة، كرم، امتنان، إخلاص. كلها تنبع من ثقة، بأنه مهما اشتدت الحياة، فالله قريب. بدأت أرى القرآن ليس مجرد كتاب احكام، بل دليلاً للبقاء، للجمال، للعدالة. رأيت الصلاة ليست واجباً، بل محادثة. و رأيت الصوم ليس عقاباً، بل تدريباً، و تذكيراً بما يهم. كل ما ظننته قيداً، بدا فجأة كحرية. لأنه كان مبنيّاً على الحقيقة، على الانسجام، على السلام. ليس كغياب للصراع، بل كقوة في وسطه. الإسلام في تلك اللحظة كان يعني "الوطن"، المكان الذي تعود إليه الروح عندما يقسو العالم. كان يعني الهوية، ليس تلك المُفروضة بالثقافة أو المجتمع، بل المختارة بأعمق أعماق القلب. كان يعني التوازن بين الكفاح و الراحة، بين هذه الدنيا و الآخرة. و كان يعني العدالة، ليس فقط في القانون، بل في كيفية تعاملك مع الآخرين، مع نفسك، في كيف تقف حتى عندما يحاول العالم إسقاطك. لم أُسلم في تلك اللحظة، لكن شيئاً بداخلي فعل. بذرةٌ زُرعت، نورٌ اشتعل، و علمت أنني لن أعود أبداً إلى رؤيتي السابقة للعالم. لأنني الآن رأيت الإسلام ليس فقط بعينيّ، بل بقلبي.
هناك فرق بين "المشاهدة" و "الرؤية". المشاهدة سلبية، هي ما تفعله عندما تقلب القنوات، أو تتصفح العناوين. هي ما يسمح لك بمشاهدة المأساة من راحتك الآمنة، ثم إغلاقها عندما تصبح ثقيلة جداً. أما الرؤية الحقيقية، فتحتاج شجاعة، تتطلب قلباً. تعني أن تخطو إلى داخل ألم الآخر. ليس لاستهلاكه، بل لفهمه، لشعوره، للتأثر به بطريقة تجعل الصمت خياراً لم يعد مقبولاً. الكثيرون يشاهدون ما يحدث لفلسطين و يسمونه "توعية". لكن الوعي دون فعل هو مجرد شكل آخر من اللامبالاة. فليس كافياً أن تقول "هذا محزن" أو "هذا مؤسف"، ثم تواصل حياتك غير متأثر. لأن ما يحدث هناك ليس مجرد قضية سياسية، بل هو اختبار لأخلاقنا الجمعية. و عدم التحدث، عدم التحرك، عدم الاكتراث حتى، هو اختيار لطرف، سواء أدركت ذلك أم لا.
لقد رأيت الحقيقة بعينيّ، نظرت إلى وجوه أمهات دفنَّ أبناءهن، سمعت القوة الهادئة في أصوات آباء ما زالوا يعلمون أطفالهم الحب في أرض علمتهم القتال. و شعرت بثقل قصةٍ حُرِّفت، دُفنت، أنكِرَت طويلاً. لذا، هذه دعوة ليس فقط للسمع، بل للإصغاء. ليس للنظر فحسب، بل للرؤية. أن ترى الناس، أن ترى إنسانيتهم، أن ترى ما وراء العناوين، ما وراء الألقاب، ما وراء الأكاذيب المريحة. لأنك بمجرد أن ترى حقاً، لا يمكنك أن تعود أعمى. لا يمكنك أن تبقى مرتاحاً في صمتك. لا يمكنك أن تستمر في التظاهر بأن الأمر لا يعنيك.
لا يجب أن تكون فلسطينياً لتقف مع فلسطين. عليك فقط أن تكون إنساناً. عليك فقط أن تهتم بما يكفي لتسمح للحقيقة بالدخول. و عندما تفعل، عندما تسمح لنفسك بأن تشعر بها، ستغيرك. ستوقظ شيئاً بداخلك. شيئاً شجاعاً، صادقاً، ضرورياً. هذا ليس عنهم فقط. هذا عنا. عن من نختار أن نكون. في عالم يتوسل إلينا أن نكترث، لا تكتفِ بالمشاهدة.
انظر! و بمجرد أن ترى، تحرّك (تكلم)!
2 Arabs
3 Others
4 Muslims
6 بالعربية


